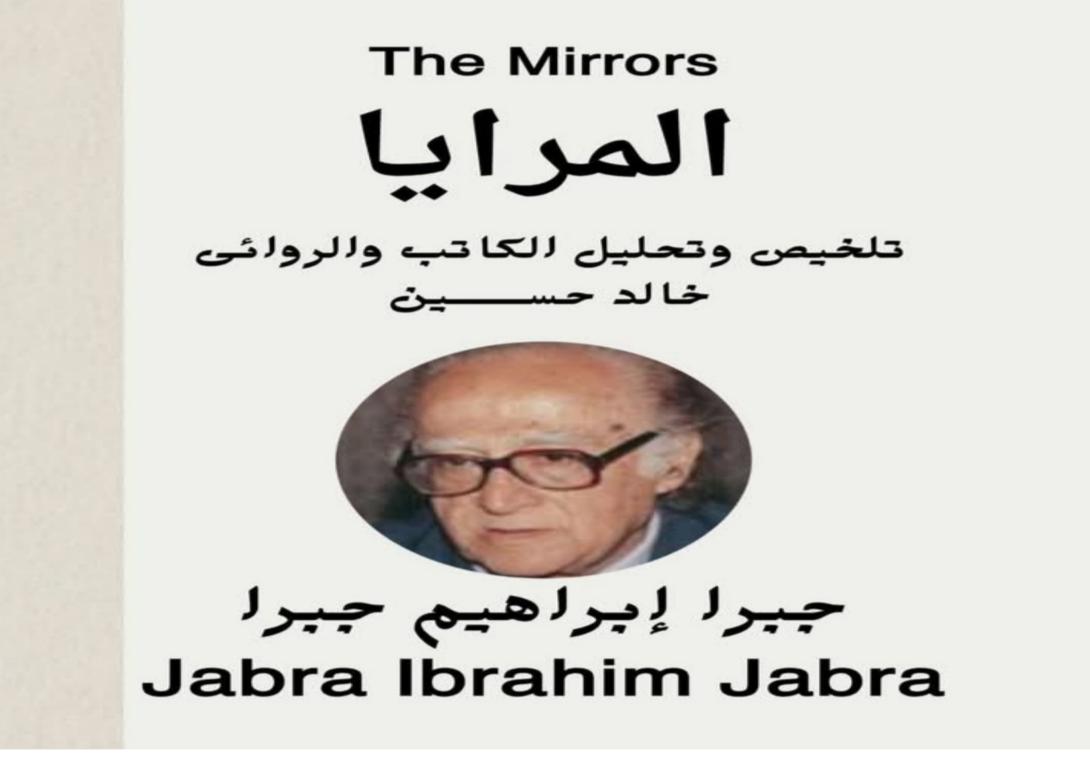المقدمة:
متاهة الذات في زمن المنفى
تعتبر رواية «المرايا» (1972) لجبرا إبراهيم جبرا منعطفًا جوهريًّا في الأدب العربي الحديث، حيث تدمج بين التساؤل الوجودي وواقع التَّشظِّي الذي يعيشه المُهَجَّرُون. وُلد جبرا في بيت لحم عام 1920، وعاش تجربة النكبة عام 1948، وهي التجربة التي طبعت مسيرته الأدبية والفكرية بعمق. تُناقش أعماله، مثل «السفينة» و«البحث عن وليد مسعود»، ثيمات المنفى والهُويَّة وصدام الحداثة العربية بالغربية. لكنّ «المرايا» تتميّز بتجريبيتها السردية وتفكيكها الجريء لفكرة الهوية الموحدة، مُصوِّرةً الذات ككيان مُتشظٍّ يتشكّل عبر مرايا الذاكرة والصدمة والاغتراب الثقافي.
تلخيص «المرايا»:
سردٌ لأطياف الهوية المبعثرة
في قلب بغداد المُثقلة بأصداء الماضي، وحيث تتعالى أصوات المُهَجَّرين والفنانين والعشاق، تدور أحداث رواية «المرايا» (1972) للروائي الفلسطيني جبرا إبراهيم جبرا، كأنها سيمفونية منكسرة تعزف على أوتار الذاكرة والضياع. تبدأ الحكاية مع وائل، مثقف فلسطيني نزح إلى العراق بعد نكبة 1948، يحمل في جيبه مفتاح بيتٍ في القدس، وفي قلبه سؤالٌ عن هويةٍ تاهت بين شظايا الزمن. وائل، الذي يعمل محررًا في مجلة ثقافية، لا يكفُّ عن مواجهة ذاته في مرايا متعددة: مرايا المقاهي التي يجلس فيها مع أصدقائه المثقفين، مرايا علاقاته العابرة مع النساء، ومرآة مكسورة في شقته البغدادية العتيقة، تلتقط صورته المشتتة كل صباح.
في عالم الرواية، لا توجد حكاية واحدة، بل حكاياتٌ متداخلة كأمواج البحر. وائل، الذي يحاول كتابة رواية عن طفولته في فلسطين، تختلط عليه الذكريات بالخيال، فيتحول الماضي إلى كابوسٍ من الصور المُتقطعة: صوت أمه وهي تهمس بالدعاء تحت شجرة الزيتون، رائحة الخبز في أزقة القدس، ودويّ القنابل الذي مزق صمت المدينة. لكن محاولاته لاستعادة تلك اللحظات تبوء بالفشل؛ فالكلمات تتحول إلى "حبر يذوب على الورق"، والذاكرة تصير سجنًا لا يُطلَق منه سراح.
وسط هذا التشظي، تظهر شخصياتٌ تحمل كل منها مرآةً تعكس جانبًا من أزمة وائل. هناك ليلى، الفتاة العراقية الغامضة التي تقع في حبه، والتي تروي له ذات ليلة كيف أنها ترى في مرآتها "امرأة أخرى تبتسم لها ببرود"، كأن جسدها صار غريبًا عنها. وهناك صديقه الشاعر خالد، ابن البصرة، الذي يكتب قصائد عن النهر الذي غرقت فيه أحلام طفولته، ويحمل في عينيه حنينًا إلى زمنٍ لم يعد موجودًا. وفي شارع الرشيد، تلتقط الرواية صدى أصوات فناناتٍ وعمالٍ ومُتسولين، كل منهم يحمل حكايةً تذكّر وائل بأن التشظي ليس مصيره وحده، بل قدرًا جماعيًّا في عالمٍ فقد بوصلته.
الحدث الأكثر إثارةً في الرواية يأتي مع لقاء وائل بنهى، الفنانة العراقية التي تصنع منحوتاتٍ من مرايا مكسورة. في مرسمها المليء بالأشباح الفنية، تعرض عليه عملها الجديد: تكوينٌ من شظايا زجاجية تعكس وجهه مئة مرة، كل انعكاس يُظهر تعبيرًا مختلفًا — خوفًا، غضبًا، حزنًا — وكأنها تجمّع كل الأطياف التي يخفيها. هنا يبدأ وائل في فهم أن هويته ليست "ذاتًا واحدة" ضائعة، بل سلسلة من الانعكاسات التي تشكلت عبر احتكاكه بالمنفى، والفن، والفقد.
لكن الرواية لا تترك وائل — أو القارئ — في سلام مع هذه الفكرة. ففي الفصول الأخيرة، تُفاجئنا الأحداث بموت خالد الغامض، الذي يُعثر عليه غارقًا في نهر دجلة، ومعه مخطوطة قصيدته الأخيرة التي تكشف عن إحساسه بأنه "شبحٌ يسكن جسدًا لا ينتمي إليه". يدفع هذا الموت وائل إلى هاويةٍ جديدة من التساؤلات، بينما تختفي ليلى فجأة، تاركةً له رسالةً تقول: "أنت تحب الشظايا لأنك تخاف من الصورة الكاملة". في النهاية، يقرر وائل مغادرة بغداد، حاملاً معه قطعةً من مرآة نهى المكسورة، كرمزٍ لاستحالة جمع الذات المُتشرذمة.
بينما تغلق الرواية صفحاتها، تترك القارئ في مواجهة أسئلة وجودية عن الهوية والانتماء: هل نحن سوى مرايا تعكس أجزاءً من الآخرين؟ وهل يمكن للفن أن يُصلح ما كسرته الحرب؟ وكيف يعيش الإنسان حين يصير وطنه ذكرى، وجسده منفى؟ «المرايا» لا تجيب، بل تكتفي بتعرية الجروح، وترك المرايا تدوّي بأصوات الشظايا
الكاتب /خالد حسين