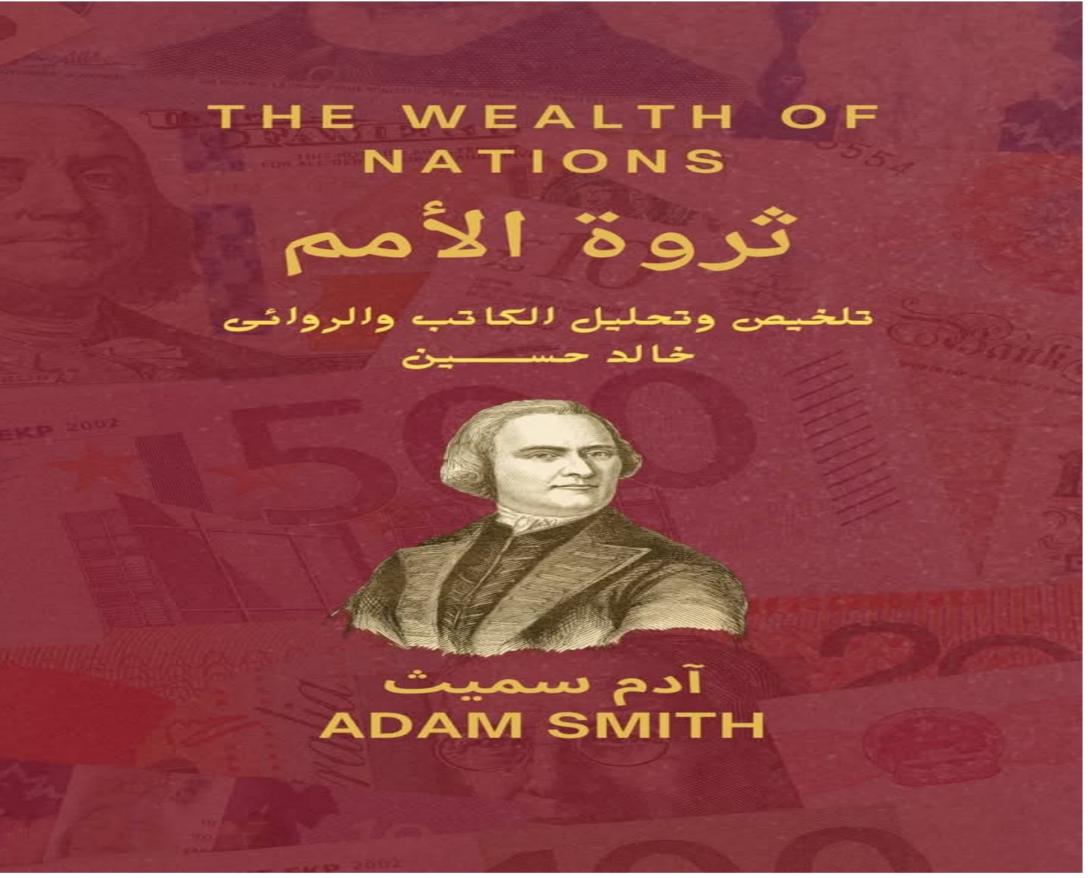المقدمة
في خضم التحولات الجذرية التي شهدها القرن الثامن عشر بين صعود عصر التنوير وانهيار الأنظمة الإقطاعية وتبلور ملامح الثورة الصناعية برز آدم سميث كواحد من أعمدة الفكر الذي أعاد تشكيل الوعي الإنساني بالاقتصاد والمجتمع. لم يكن كتابه "ثروة الأمم" (1776) مجرد مؤلفٍ أكاديميٍّ يشرح آليات السوق، بل كان مشروعاً فلسفياً طموحاً يهدف إلى فكِّ شفرةٍ وجودية: كيف تُبنى الحضارات؟ وما الذي يجعل الأمم غنيةً أو فقيرة؟ انطلاقاً من هذه الأسئلة، نسج سميث تحليله عبر خمسة مجلداتٍ تجمع بين الملاحظة الدقيقة للواقع الاقتصادي اليومي من ورشات العمل الصغيرة إلى شبكات التجارة العالمية والتفكير المجرد في مفاهيم مثل القيمة، الحرية، والعدالة. لم يقتصر عمله على تأسيس علم الاقتصاد الحديث، بل طرح رؤيةً شاملةً للطبيعة البشرية، حيث تتفاعل الأنانية الفردية مع الغريزة الاجتماعية لخلق نظامٍ معقدٍ من التبادلات التي تُعَظِّم الرفاهيةَ الجماعية.
لكنَّ عبقرية الكتاب لا تكمن فقط في ما قاله، بل في ما أثارَهُ من أسئلةٍ لم تُحسَم حتى اليوم: هل يمكن فصل الأخلاق عن الاقتصاد؟ وهل يكفي تحرير السوق لضمان التقدم؟ وكيف تُوازن بين حرية التاجر وحقوق العامل؟ هذه الإشكاليات التي ناقشها سميث بمنهجيةٍ تجمع بين السرد التاريخي والتحليل النظري جعلت من "ثروة الأمم" نصًّا مفتوحاً على تأويلاتٍ متضاربة: فبينما رأى فيه الليبراليون دستوراً للرأسمالية، وجد الاشتراكيون بين سطوره نقداً مبكراً لتفاوتاتها. حتى على المستوى الأكاديمي، لا يزال الجدل قائماً حول مدى تماسك رؤيته: فهل كان سميث فيلسوفاً أخلاقياً حاول فهم الاقتصاد، أم اقتصادياً استعار أدوات الفلسفة؟
هذه المقدمة لا تهدف فقط إلى استعراض أفكار الكتاب، بل إلى تفكيك الطبقات المتداخلة التي تشكِّل نسيجه: من السياق التاريخي الذي ولد فيه (حروب الاستعمار، صعود البرجوازية، تحولات مفهوم العمل)، إلى الجذور الفلسفية لتنظيره (تأثره بكل من ديفيد هيوم وفرانسوا كيناي)، وصولاً إلى الثغرات التي تركها عمداً أو سهواً ليتصدى لها قُرَّاؤه عبر العصور. فـ"ثروة الأمم" ليس كتاباً عن المال، بل عن السلطة، الهوية، والعلاقة بين الفرد والمجتمع وهو ما يجعله مرآةً تعكس تناقضات الحداثة نفسها.
تلخيص الكتاب.
سردٌ لحكاية تأسيس الاقتصاد الحديث
في ربيع عام 1776، بينما كانت المستعمرات الأمريكية تُعلن استقلالها عن بريطانيا، ظهر كتابٌ غيَّر مصير العالم الاقتصادي إلى الأبد: "تحقيق في طبيعة وأسباب ثروة الأمم" لـآدم سميث، الفيلسوف الأسكتلندي الذي صاغ مبادئَ ما يُعرف اليوم بـ"الاقتصاد الكلاسيكي". هذا الكتاب، الذي امتد على خمسة مجلداتٍ ضخمة، لم يكن مجرد دراسةٍ جافةٍ للأرقام أو التجارة، بل كان رحلةً فلسفيةً عميقةً لفهم كيف تُخلق الثروة، ولماذا تزدهر بعض الأمم بينما تتراجع أخرى، وكيف تُحرِّك الغرائزُ البشريةُ عجلةَ التاريخ.
الفصل الأول: من الدبابيس إلى العالم
يبدأ سميث رحلته بمشهدٍ بسيطٍ يخفي وراءه عالماً من التعقيد: "مصنع الدبابيس". هنا، يشرح كيف أن تقسيم العمل إلى مهامٍ صغيرةٍ متكررةٍ مثل تمديد السلك، أو شحذه، أو تركيب الرأس يزيد الإنتاجيةَ مئات المرات. هذه الفكرة، التي تبدو بديهيةً اليوم، كانت ثوريةً في زمنٍ كان الحرفيون فيه يصنعون كل شيءٍ بأيديهم. لكن سميث لم يتوقف عند التكنولوجيا؛ بل رأى في هذا التقسيم استعارةً للحضارة الإنسانية نفسها: التخصص يولِّد التبادل، والتبادل يولد الترابط بين البشر، ومن هذا الترابط تنبثق المدنُ والأسواقُ والدول.
اليد الخفية:
حين تتحول الأنانية إلى نظامٍ أخلاقي.
في قلب الكتاب، يطرح سميث فكرته الأكثر إثارةً للجدل: "اليد الخفية". يروي لنا كيف أن الجزارَ والخبازَ لا يقدمان لنا طعاماً بدافع الإحسان، بل بدافع المصلحة الشخصية. لكن عبر آلاف المعاملات اليومية، تتحول هذه المصلحة الفردية دون تخطيطٍ مركزي إلى نظامٍ يضمن توفير السلع بأسعارٍ عادلةٍ وجودةٍ متزنة. هنا، ينسج سميث خيطاً رفيعاً بين الفلسفة الأخلاقية (التي تناولها في كتابه السابق "نظرية المشاعر الأخلاقية") والاقتصاد: فالسوق، في نظره، ليس آلةً ماديةً فحسب، بل هو نتاجٌ لـ"المشاعر الأخلاقية" التي تدفع البشر للتعاون حتى وهم يبحثون عن منفعتهم.
♧ هجومٌ على عمالقة الماضي:
تفكيك أسطورة المركنتيلية.
لا يكتفي سميث ببناء نظريته، بل يهدم ببرودٍ أكاديميٍّ صروحَ النظام الاقتصادي السائد في أوروبا المركنتيلية (Mercantilism) الذي اعتقد أن ثروةَ الأمم تُقاس بكمية الذهب الذي تخزنه، فشجَّع الاحتكاراتِ الحكوميةَ والحروبَ التجارية. يشرح سميث، بمثابرةِ محققٍ جنائي، كيف أن هذه السياسات مثل قيود الاستيراد أو دعم الصناعات المحلية تُضعف الاقتصادَ على المدى الطويل، وتُفقِد المستهلكَ خياراتٍ أفضلَ وأرخص. بل يذهب إلى أبعد من ذلك: "الدولة ليست أذكى من السوق"، يقول، فحتى لو نوى الحاكمُ الخير، فإن جهله باحتياجات الملايين سيقوده إلى قراراتٍ كارثية.
الدولة:
حارسةٌ لا لاعبٌ أساسي.
رغم تصويره السوقَ كقوةٍ طبيعيةٍ ذاتية التنظيم، إلا أن سميث لا يطالب بإلغاء الدولة. بل يرسم لها دوراً دقيقاً: حماية المجتمع من الغزو الخارجي (الجيش)، إنشاء نظام قضائي عادل يحمي الملكية ويحل النزاعات، وبناء مشاريع البنية التحتية (مثل الطرق والموانئ) التي لا يستطيع الأفرادُ تحمل تكلفتها. أما فيما عدا ذلك، فالدولة في نظره يجب أن تبقى خارج اللعبة الاقتصادية، لأن تدخلها يُعطِّل "التوازن الطبيعي" للسوق.
الثروة ليست ذهباً:
إعادة تعريف الغنى.
في أحد أعمق أجزاء الكتاب، يقلب سميث المفهومَ السائدَ للثروة. فبدلاً من التركيز على الذهب أو الأراضي كما فعل الفيزيوقراطيون (Physiocrats) يرى أن الثروة الحقيقية هي "القدرة على إنتاج السلع والخدمات". هنا، يُدخلنا إلى عالم "القيمة" و"الأسعار"، مفرقاً بين "قيمة الاستعمال" (فائدة الشيء) و"قيمة التبادل" (سعره في السوق). ويحذر من أن اختلال هذه العلاقة كما في احتكار السلع الأساسية قد يُحوِّل الثروةَ من أداةٍ لتحسين الحياة إلى وسيلةِ استغلال.
الكتاب الذي رأى المستقبل ولم يُحْسِنْ قراءته.
رغم رؤيته الثورية، يبدو سميث في بعض الصفحات أسيرَ عصره. فهو يكتب عن "اقتصادٍ زراعيٍّ وصناعي"، دون أن يتخيل ثورةَ الخدمات أو الرقمنة. كما أن تحليله لدور المرأة يكاد يكون غائبًا، ويعتبر عملَها جزءًا من "الاقتصاد المنزلي" غير المُنتج. لكن هذه الثغرات لا تُقلل من عبقرية الرجل الذي تنبأ قبل قرون بمخاطر الاحتكارات، وأدرك أن التعليمَ العام هو استثمارٌ ضروريٌ لضمان كفاءة السوق، وحذَّر من أن إهمال العمال بدنياً وأخلاقياً سيهدد استقرار المجتمع نفسه.
-إرثٌ لا ينتهي.
عندما أغمض سميث عينيه عام 1790، لم يكن يعلم أن كتابه سيصير "إنجيل الرأسمالية"، ولا أن نقاده من ماركس إلى كينز سيجعلون منه نقطةَ حوارٍ دائمة. اليوم، في عصر العولمة والأزمات البيئية، ما زال السؤال الذي طرحه سميث يتردد: هل يكفي أن نتبع "اليد الخفية" لتحقيق الازدهار، أم أن ثروة الأمم تحتاج إلى يدٍ مرئيةٍ ترسم مساراً أكثر إنصافاً؟ الجواب، ربما، لا يوجد في كتابٍ واحد، لكن "ثروة الأمم" يظل الباب الذي لا بد من عبوره للبحث عنه