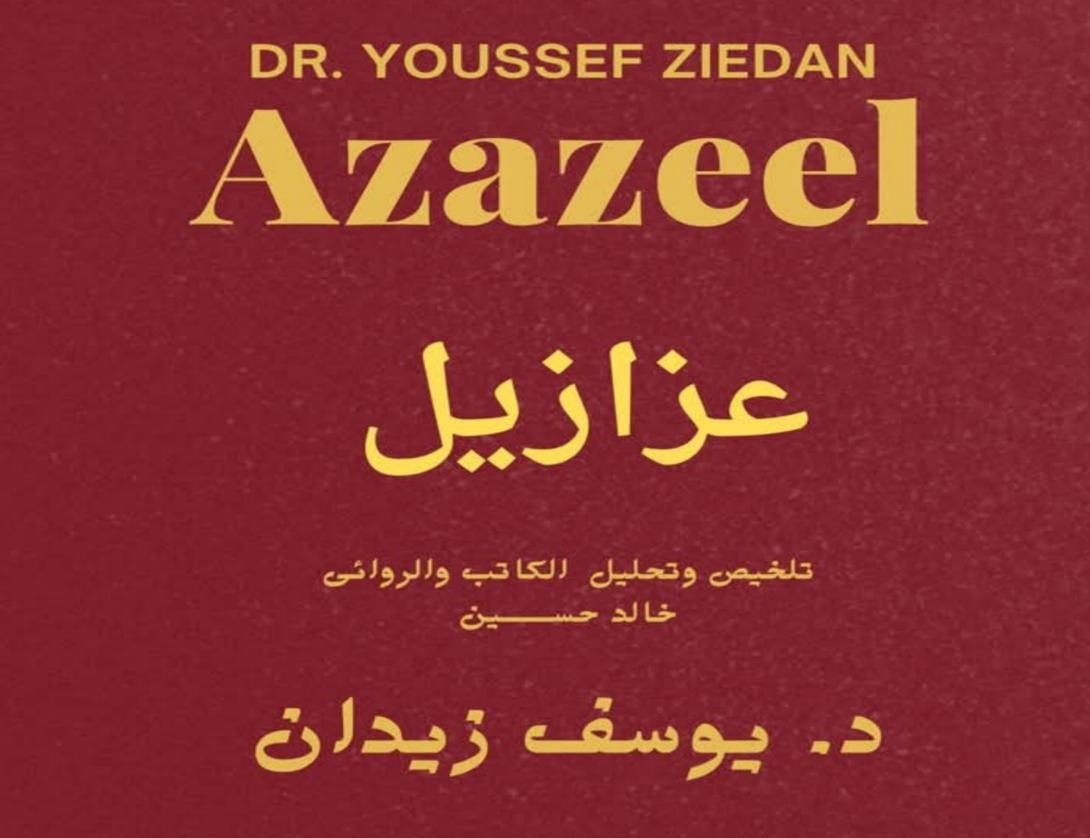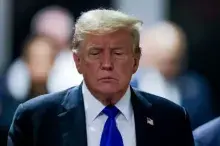تلخيص الرواية.
رحلةٌ بين صراعات الإيمان والهوية.
في رواية "عزازيل"، التي تتخذ شكل مخطوطاتٍ سريانيةٍ قديمةٍ مُكتشفة قرب دير القديس سمعان في حلب، ينسج د.يوسف زيدان حكايةً دراميةً تُمزج التاريخ بالأسئلة الوجودية، عبر سرد الراهب المصري "هيبا" لسيرته الذاتية في القرن الخامس الميلادي. تبدأ الرواية باكتشافٍ مثيرٍ لمجموعة لفائف مكتوبة بالخط السرياني، تُرجمت لاحقًا إلى العربية، مدّعيةً أنها تسرد وقائع حقيقية عاشها راهبٌ مسيحي خلال فترة مضطربة من تاريخ الكنيسة، حيث كانت المسيحية تتحول من دين مضطهد إلى دينٍ رسمي للإمبراطورية الرومانية، وسط صراعاتٍ عقائدية عنيفة حول طبيعة المسيح.
يُقدّم "هيبا"، بطل الرواية، نفسه كراهبٍ طبيبٍ نشأ في صعيد مصر، ثم انتقل إلى الإسكندرية لدراسة الطب والفلسفة، حيث شهد تحولاتٍ مجتمعيةً عميقة بعد قرار الإمبراطور ثيودوسيوس بتحريم الوثنية. هنا، تبدأ رحلة الشك التي تطارد البطل، خاصةً بعد مشاهدته مقتل الفيلسوفة "هيباتيا" على يد جماعة مسيحية متطرفة، وهو حدثٌ تاريخي يُصوَّر بدقةٍ كرمزٍ لانتصار التعصب على العقل. تتوالى الأحداث بانتقال "هيبا" إلى القدس، ثم حلب، حيث يواجه تناقضات الكنيسة بين تعاليم المحبة وممارسات العنف ضد المخالفين، مثل اضطهاد النساطرة وأتباع آريوس، في إشارةٍ إلى الصراعات المذهبية التي شهدها مجمع نيقية.
في قلب هذه الرحلة الجغرافية والفكرية، يظهر "عزازيل" كصوتٍ داخليٍ يطارده، يجسّد الشك والرغبات المكبوتة. الحوارات الفلسفية بين "هيبا" و"عزازيل" – الذي يتبدى أحيانًا ككائنٍ ملموسٍ في الرواية – تكشف عن أزمة البطل مع الإيمان: هل الخطيئة جزء من طبيعة الإنسان؟ هل العنف باسم الدين هو انحراف عن جوهره؟ تُصوَّر هذه الحوارات بلغةٍ شعريةٍ عميقة، تخلط بين الاستشهادات الدينية والمنطق الفلسفي، وتعكس تأثر زيدان بتراث التصوف الإسلامي، خاصةً في تصوير الشيطان ليس كعدوٍ خارجي، بل كجزءٍ من النفس البشرية.
لا تقتصر الرواية على سرد الأحداث، بل تُقدّم بانوراما تاريخيةً دقيقةً للحقبة، بدءًا من وصف الحياة في الأديرة، ومرورًا بالصراعات بين المذاهب المسيحية حول طبيعة المسيح (اللاهوت والناسوت)، ووصولًا إلى التفاصيل اليومية للمجتمعات القديمة، كالطب والعلاقات الاجتماعية. لكن التوثيق التاريخي يمتزج بخيالٍ روائيٍ جريء، خاصةً في تصوير العلاقة المحرمة بين "هيبا" وامرأةٍ تدعى "أوكتافيا"، والتي تتحول إلى رمزٍ لصراعه بين الرهبانية والرغبة الإنسانية.
تنتهي الرواية بمفارقةٍ مأساوية، حيث يُدفع "هيبا" – بعد سنواتٍ من الهروب من ذاته – إلى كتابة اعترافاته في كهفٍ منعزل، تاركًا أسئلته دون إجابات قاطعة: هل كان "عزازيل" شيطانًا خارجيًا، أم هو الصوت الداخلي لضميرٍ ممزق؟ وهل يمكن للإنسان أن يهرب من ذاته مهما ابتعد جغرافيًا؟ تُختتم المخطوطات بإحساسٍ بالغموض، تاركةً القارئ في مواجهة تلك الأسئلة، كأنها مرآةٌ تعكس إشكالياتٍ إنسانيةً خالدة: ثنائية الإيمان والشك، وصراع الهوية بين الفرد والمجتمع، ودور الدين بين التحرر والقمع.
هكذا، تتحول "عزازيل" من سردٍ تاريخيٍ إلى روايةٍ كونية، تلامس قضايا معاصرةً من خلال استحضار الماضي، مُستخدمةً اللغة كجسرٍ بين الواقع والمتخيل، وبين الفردي والجماعي، في عملٍ يُعيد تعريف حدود الرواية التاريخية العربية.