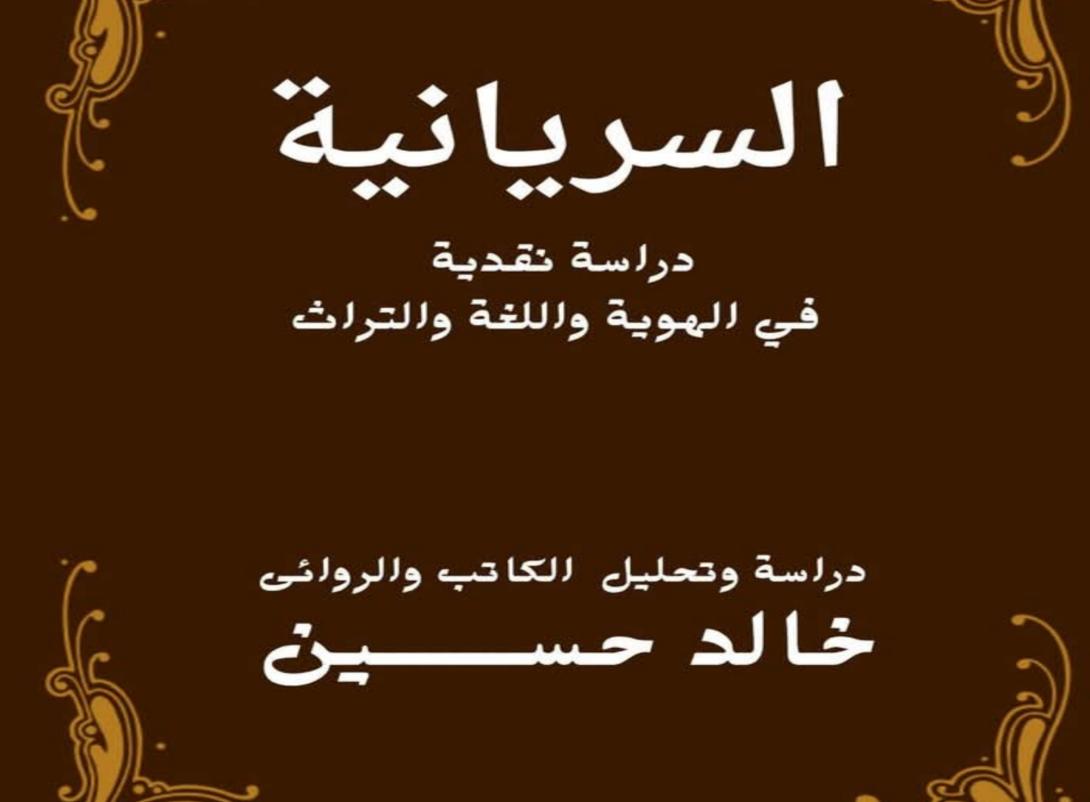- المقدمة
تمثل السريانية ظاهرة ثقافية ولغوية وتاريخية فريدة في قلب الشرق الأوسط، حيث تتداخل فيها طبقات الهويات الدينية والعرقية والسياسية بتعقيد يجسد تحولات المنطقة نفسها. لا تقتصر السريانية على كونها لغة سامية تطورت من الآرامية القديمة، أو مجرد أداة لنقل النصوص المسيحية المبكرة، بل هي وعاء لحضارة إنسانية راكمت إرثًا فكريًا وروحيًا امتد من القرن الأول الميلادي حتى اليوم، متجاوزة حدود الجغرافيا والدين. تطرح هذه الدراسة في سياق أكاديمي نقدي يهدف إلى تفكيك السرديات التقليدية التي غالبًا ما اختزلت السريان في دورهم كلاهوتيين أو أقليات، بينما تظهر الوثائق التاريخية والمخطوطات السريانية أنهم كانوا فاعلين مركزيين في تشكيل الحضارات القديمة والوسيطة، من خلال نقل المعارف اليونانية إلى العربية، وصياغة مفاهيم فلسفية عبرت عن حوار عميق بين الشرق والغرب.
تتطلب دراسة السريان منهجية متعددة التخصصات، تجمع بين التحليل اللغوي المقارن، وقراءة النصوص الدينية في سياقاتها السياسية، وتفكيك الروايات التاريخية المتنافسة حول أصلهم. فمن ناحية، يجادل باحثون مثل سيباستيان بروك بأن الهوية السريانية تشكلت ككيان مستقل مع تبني المسيحية في القرون الأولى، حيث تحولت الآرامية - بلهجة الرها - إلى لغة مقدسة للطقوس واللاهوت، مما أضفى عليها طابعًا هوياتيًا جديدًا. ومن ناحية أخرى، يشير علماء مثل هانز دريفرز إلى استمرارية الوعي الآرامي ما قبل المسيحي في التقاليد السريانية، مستندين إلى نقوش وآثار تظهر تداخلًا ثقافيًا بين الموروثين.
لا يقتصر التحدي الأكاديمي هنا على الجدل حول الأصول، بل يمتد إلى فهم التفاعل بين السريان والإمبراطوريات المتعاقبة (الرومانية، الساسانية، الإسلامية)، حيث اضطلعوا بأدوار متناقضة ظاهريًا: كرعايا أحيانًا، وكمترجمين ومستشارين في بلاط السلطة أحيانًا أخرى. هذا الانزياح بين المركز والهامش يطرح أسئلة جوهرية حول مفاهيم "التبعية" و"الاستقلالية الثقافية"، خاصة في ظل سياسات التسامح أو الاضطهاد التي مارستها هذه الإمبراطوريات تجاه الأقليات.
على الصعيد اللغوي، تقدم السريانية نموذجًا استثنائيًا لـ"لغة مقدسة" حافظت على حيويتها رغم انحسارها كلغة أم، بفضل نصوصها الليتورجية الغنية وأدبها التاريخي والعلمي. ومع ذلك، فإن الانزياحات اللهجية بين السريانية المشرقية (المنتمية لكنيسة المشرق) والغربية (المرتبطة بالسريان الأرثوذكس) تعكس انقسامات لاهوتية وسياسية عميقة، مثل الانشقاق بعد مجمع أفسس (431 م) الذي حول الاختلافات العقيدية إلى هويات منفصلة.
في العصر الحديث، تواجه السريانية تحديًا وجوديًا مع تناقص عدد الناطقين بها، وهجرة المجتمعات السريانية من مواطنها الأصلية في العراق وسوريا وتركيا بسبب الصراعات. لكن هذا الواقع ينتج في المقابل محاولات جادة لإحياء اللغة عبر منصات رقمية ومبادرات أكاديمية، مثل مشروع "قيثارة الشرق" لتدريس السريانية عبر الإنترنت، أو اعتمادها كلغة تعليم في بعض مدارس شمال العراق. هذه الجهود تثير أسئلة نقدية حول إمكانية فصل الهوية السريانية عن الإطار الديني، وتحويلها إلى هوية ثقافية عابرة للحدود، في عالم تزداد فيه الهويات المرنة هيمنة.
من هنا، تهدف هذه الدراسة إلى تقديم قراءة شمولية تعيد ربط الماضي بالحاضر، من خلال تحليل النقاط التالية:
1. التفاعل بين الموروث الآرامي والتحول المسيحي في تشكيل الهوية السريانية.
2. دور السريان كوسطاء ثقافيين بين الإمبراطوريات، وانعكاسات ذلك على بقاء لغتهم.
3. إشكالية الهوية في الأدب السرياني، بين السرد الذاتي والرواية الخارجية.
4. التحولات المعاصرة وتأثير العولمة على مستقبل السريانية كلغة وهوية.
تعتبر هذه المقالة إسهامًا في حقل الدراسات السريانية الذي لا يزال يعاني من هيمنة النهج التبسيطي، سواء في تصوير السريان كضحايا دائمين للاضطهاد، أو كمجرد جسر حضاري اختفى مع صعود العربية. عبر الجمع بين المنهج التاريخي النقدي وتحليل النصوص السريانية الأولية، تسعى هذه الدراسة إلى كشف التعقيدات التي صنعت - ولا تزال تصنع - حكاية السريان ولغتهم.
- الفصل الأول:
الجذور التاريخية للسريان – التمازج بين الآرامية والمسيحية وتشكل الهوية.
تشكل الجذور التاريخية للسريان إشكالية بحثية معقدة، حيث تتداخل فيها الطبقات الثقافية والدينية واللغوية لشعوب بلاد ما بين النهرين وسوريا الكبرى، في عملية تحولية امتدت قرونًا طويلة. يعود أصل السريان، وفقًا للدراسات الأنثروبولوجية واللغوية الحديثة، إلى الآراميين، الذين هيمنوا على المشهد الثقافي للشرق الأدنى القديم منذ الألفية الأولى قبل الميلاد، حيث أسسوا ممالك مثل مملكة آرام-دمشق، وانتشروا كلغة تواصل مشتركة (لينغوا فرانكا) في الإمبراطورية الفارسية الأخمينية. ومع ذلك، فإن التحول الجذري في تشكل الهوية السريانية ككيان متميز يرتبط بالقرون الأولى للمسيحية، حين تحولت الآرامية - بلهجة الرها (أورهاي) - إلى لغة طقسية ولاهوتية، حاملة معها رؤية دينية وثقافية جديدة.
هنا يبرز الجدل الأكاديمي حول طبيعة هذه الهوية: هل هي امتداد طبيعي للوعي الآرامي ما قبل المسيحي، أم أنها تشكلت ككيان منفصل مع تبني المسيحية؟ يجادل سيباستيان بروك بأن مصطلح "سرياني" (ܣܘܪܝܝܐ) لم يظهر كتسمية ذاتية إلا في القرن الرابع الميلادي، مع تحول الرها إلى مركز مسيحي، حيث استبدلت تسمية "آرامي" بـ"سرياني" كجزء من عملية إعادة تعريف الهوية الدينية، مما يعكس قطيعة رمزية مع الماضي الوثني. في المقابل، يشير هانز دريفرز إلى استمرارية ثقافية من خلال تحليل النقوش والكتابات الآرامية قبل المسيحية في الرها، مثل نص "قبر سرجون" (القرن الثاني الميلادي)، الذي يظهر تشابهًا لغويًا ودينيًا مع المفاهيم السريانية اللاحقة، كالتركيز على "الآلهة المحلية" التي تحولت لاحقًا إلى رموز مسيحية.
لا يمكن فصل هذا الجدل عن السياق السياسي والديني الأوسع: ففي القرون الأولى الميلادية، كانت منطقة شمال بلاد الرافدين ساحة لتنافس الإمبراطوريتين الرومانية والفارسية، ثم الساسانية، مما دفع المجتمعات المحلية إلى صياغة هوية ثقافية تعكس ولاءات مرنة. في هذا الإطار، أصبحت الرها، بحكم موقعها الحدودي، بوتقة لتمازج التأثيرات الهلنستية والآرامية، حيث ترجمت الأعمال اليونانية إلى الآرامية، وطورت أولى أشكال الأبجدية السريانية (الإسترنجيلو) كتطور طبيعي للأبجدية الآرامية القديمة.
لكن التحول الأهم حدث مع تبني المسيحية، التي لم تقدم كدين جديد فحسب، بل كـ"نظام ثقافي" أعاد تشكيل الرموز الآرامية. فمثلًا، الإله الآرامي "بعل شامين" (سيد السماوات) تحول في الأدب السرياني إلى تسمية للمسيح كـ"رب السماء والأرض"، وفقًا لنصوص مثل "كتاب العادات" (ܟܬܒܐ ܕܬܟ݂ܣܐ) للقرن الثالث. هذا الانزياح الرمزي يظهر كيف تم توظيف الموروث الديني الآرامي لخدمة السردية المسيحية، مما يشير إلى عملية "تثاقف" (Acculturation) معقدة، وليس قطيعة مفاجئة.
من جهة أخرى، تقدم المصادر السريانية نفسها رواية تأسيسية لهويتهم، مثل "عقيدة أداي" (ܡܠܦܢܘܬܐ ܕܐܕܝ) التي تنسب إلى القرن الثاني، وتزعم أن المسيحية وصلت إلى الرها عبر الرسول أداي (ثداوس)، محولة المدينة إلى "أول مملكة مسيحية". لكن التحليل النقدي لهذه النصوص، كما فعلت سوزان أشبروك في دراستها عام 2013، يكشف أنها كتبت في القرن الرابع كجزء من مشروع لتأصيل الهوية السريانية في مواجهة الهيمنة اليونانية والرومانية، مما يعكس صراعًا على الشرعية التاريخية.
ختامًا، فإن الهوية السريانية نتاج لتفاعل ثلاثي الأبعاد:
1. الاستمرارية الثقافية مع التراث الآرامي، الممثل في اللغة والعادات.
2. التحول الديني مع المسيحية، الذي أعاد تشكيل الرموز والهوية.
3. السياق الجيوسياسي الذي فرض على السريان صياغة هوية مرنة تتعايش مع الإمبراطوريات المتصارعة.
هذا التمازج يجعل من الصعب اختزال السريان في "آراميين مسيحيين" أو "مسيحيين شرقيين"، بل هم كيان متنوع، ولد من رحم الحوار بين القديم والجديد، والشرق والغرب.
- الفصل الثاني:
اللغة السريانية – من اللهجة المحلية إلى نظام عالمي للفكر والروح.
تعتبر اللغة السريانية أحد أبرز الأمثلة على تحول لهجة محلية إلى لغة عالمية حملت مشعل الحضارة بين الشرق والغرب، حيث تجاوزت وظيفتها التواصلية لتصبح أداة لتشكيل الهوية ونقل المعارف عبر الأديان والإمبراطوريات. انبثقت السريانية من رحم الآرامية الشرقية، وتحديدًا لهجة الرها، التي تطورت في القرون الأولى قبل الميلاد كـ"لينغوا فرانكا" للإدارة والتجارة في الهلال الخصيب. لكن التحول الجذري حدث مع تبني المسيحية، حيث أصبحت السريانية لغة ليتورجية وعلمية، مطورة أبجدية متميزة (الإسترنجيلو) اشتقت من الآرامية الملكية، لكنها أضافت علامات حركية دقيقة في القرن السابع لضبط النطق، مما حولها إلى نظام كتابي قادر على التعبير عن المفاهيم اللاهوتية المعقدة.
هذا التطور اللغوي لم يكن محايدًا، بل ارتبط بصراعات الهوية والسيادة: فبينما اعتمدت الكنيسة السريانية الغربية (الأرثوذكسية) أبجدية مستديرة الحروف (السيرتو)، حافظت الكنيسة المشرقية (النسطورية) على الإسترنجيلو الأصلي، مما يعكس انقسامًا ثقافيًا عميقًا تجذر بعد مجمع أفسس (431 م) ومجمع خلقيدونية (451 م). هنا يبرز سؤال مركزي: هل كان الاختلاف اللهجوي بين الشرقية (الملبارية لاحقًا) والغربية انعكاسًا لانشقاقات لاهوتية، أم أنه نتاج لتباينات جيوسياسية أقدم؟ تشير أعمال ثيودور نولدكه إلى أن الانقسام اللغوي سبق الانقسام الكنسي، حيث كانت لهجة الرها (الغربية) تختلف صوتيًا ومورفولوجيًا عن لهجات بلاد النهرين (الشرقية) منذ العصر الآرامي.
على الصعيد الأدبي، تميزت السريانية بثنائية فريدة بين النصوص الدينية والعلمانية. فمن جهة، أنتجت تراثًا ليتورجيًا ضخمًا، مثل "الپشيطتا" (الترجمة السريانية للكتاب المقدس)، التي تعتبر أقدم ترجمة مسيحية للإنجيل، وفقًا لدراسات مايكل ويسر حول مخطوطات القرن الخامس. ومن جهة أخرى، برع السريان في التأريخ والطب والفلسفة، حيث نقلوا أعمال جالينوس وأرسطو إلى العربية في العصر العباسي، عبر مدارس مثل جنديسابور ونصيبين. لكن التحليل النقدي لهذا الدور، يكشف أن السريان لم يكونوا مجرد نَقَلة سلبيين، بل أعادوا صياغة النصوص اليونانية وفق رؤيتهم الثقافية، مثل تحويل مصطلح "لوغوس" الفلسفي إلى "مِلْثا" (ܡܠܬܐ) السرياني، الذي يحمل دلالات مسيحية لاهوتية (الكلمة المتجسدة).
أما على مستوى البنية اللغوية، فإن السريانية الكلاسيكية (القرن الثالث إلى الثالث عشر) تظهر تمايزًا واضحًا عن الآرامية القديمة في النحو والمفردات، مع تأثر كبير باليونانية في المصطلحات الفلسفية (مثل "فيلوسوفوس" → "فيلوسوفا")، وبالفارسية في المفردات الإدارية (مثل "داستكار" ← "ܕܐܣܛܩܪ" بمعنى وثيقة). هذا التهجين اللغوي يشير، كما يرى جورج كيراز، إلى أن السريانية كانت لغة "الهامش المبدع"، التي استوعبت تأثيرات الإمبراطوريات دون أن تفقد جوهرها.
لكن هذه الحيوية اللغوية لم تمنع انحسار السريانية كلغة أم بعد القرن الثالث عشر، مع صعود العربية والتركية. اليوم، تصنف السريانية كلغة مهددة بالانقراض وفق اليونسكو، لكنها تحتفظ بحضور رمزي قوي عبر الليتورجيا والأدب الكلاسيكي. هذا التناقض بين الماضي المجيد والحاضر الهش يدفع إلى إعادة النظر في مفهوم "موت اللغات"، حيث تقدم السريانية نموذجًا لـ"لغة مقدسة" تعيش في طقوسها أكثر من حياتها اليومية،
في الختام، فإن اللغة السريانية ليست مجرد نظام لغوي، بل هي سجل حي لتفاعل الهويات والسلطات. فمن خلال تتبع تحولاتها من اللهجة إلى الأبجدية العالمية، يمكن فهم كيف حول السريان لغتهم إلى فضاء مقاوم للنسيان، حتى عندما بدأ العالم حولهم يتحدث بلغات الإمبراطوريات الغالبة.
- الفصل الثالث:
السريان والإمبراطوريات – التكيف والوساطة الثقافية في عصر التقلبات الجيوسياسية
مثل السريان ظاهرة فريدة في تعايشهم مع الإمبراطوريات الكبرى، حيث نجحوا في تحويل موقعهم الهامشي إلى مركز ثقافي مؤثر عبر آليتي التكيف والوساطة. في الإمبراطورية البيزنطية، لعب السريان الغربيون (المونوفيزيون) دورًا مزدوجًا: كرعايا مهمشين عقائديًا بعد مجمع خلقيدونية (451 م)، وكعلماء في أنطاكية حولوا التراث اليوناني إلى سرياني، مثل سرجيو الرأسعيني الذي ترجم أعمال أرسطو. في المقابل، ازدهر السريان الشرقيون (النساطرة) تحت الحكم الساساني، حيث منحهم الملك كسرى الأول ملاذًا عقائديًا مقابل خدماتهم كأطباء ومترجمين، مشكلين شبكة علمية امتدت من مدرسة نصيبين إلى جنديسابور، التي أصبحت لاحقًا مصدرًا رئيسيًا للطب في العصر العباسي.
مع الفتح الإسلامي، دخل السريان في نظام "أهل الذمة"، لكن وضعهم كمترجمين وحكماء في بلاط الخلفاء، خاصة العباسيين، منحهم نفوذًا يفوق وضعهم القانوني. هنا تبرز إشكالية الولاء المزدوج: فمن جهة، كان السريان شركاء في مشروع الترجمة العالمي في "بيت الحكمة" ببغداد، حيث نقل حنين بن إسحاق (ت. 873 م)، وهو سرياني نسطوري، عشرات الأعمال اليونانية إلى العربية عبر السريانية. ومن جهة أخرى، حافظوا على هويتهم عبر الأديرة المعزولة، مثل دير الزعفران، الذي أصبح مركزًا لكتابة المخطوطات بلغتهم الأم. هذا الانزياح بين الاندماج والانكفاء يظهر، كما يرى سيدني غريفيث، أن السريان استخدموا معرفتهم كـ"عملة ثقافية" للتفاوض على بقائهم.
لكن هذه الوساطة لم تكن خالية من المخاطر: ففي القرن العاشر، مع صعود التوجهات الإسلامية المتعصبة، تعرض بعض السريان للاضطهاد، كما في حالة الطبيب المسيحي يوحنا بن ماسويه، الذي أجبر على اعتناق الإسلام، مما أدى إلى إعدامه عام 857 م. هذه الحوادث تكشف هشاشة موقع السريان رغم نفوذهم، حيث كانت حمايتهم تعتمد على إرادة الحاكم الشخصية أكثر من الحقوق المؤسسية.
من الناحية الاقتصادية، سيطر السريان على شبكات التجارة بين الشرق والغرب، خاصة في نقل الحرير والورق، مستفيدين من انتشار أديرتهم على طرق القوافل. لكن تحليل السجلات الضريبية العباسية، كما في أبحاث موريسيو بورمان، يظهر أن ثراء بعض العائلات السريانية (مثال: آل بختيشوع) أثار حفيظة المجتمع المسلم، مما عمق الفجوة الطبقية وأسهم في تصاعد العداء الطائفي.
في الختام، لم يكن تعايش السريان مع الإمبراطوريات مجرد استراتيجية بقاء، بل مشروعًا ثقافيًا معقدًا، حولهم من رعايا إلى وسطاء، ومن ضحايا التاريخ إلى صناعه. إلا أن هذه الوسطية نفسها جعلتهم عرضة لرياح التغيير السياسي، التي لم تفرق بين مخطوطاتهم الثمينة وشرنقتهم الهشة.
-الفصل الرابع:
التراث الأدبي السرياني – سرد الذات بين المقدس والتاريخي.
يمثل الأدب السرياني نسيجًا معقدًا من النصوص التي تجسد حوارًا دائمًا بين الذات والآخر، بين الروحي والدنيوي، وبين الذاكرة الجماعية والنسيان المتعمد. لم يكن هذا الأدب مجرد وعاء لحفظ العقيدة أو تسجيل الأحداث، بل كان أداة فاعلة في تشكيل الهوية السريانية عبر صياغة سرديات تتعالق مع السياقات السياسية والثقافية المتغيرة. ينقسم هذا التراث إلى محورين رئيسيين:
الأول: الأدب الليتورجي – لاهوت شعري وهوية طقسية.
احتلت النصوص الليتورجية مكانة مركزية في الأدب السرياني، حيث حول الشعر الديني، كما في قصائد أفرام السرياني (القرن الرابع)، العقيدة إلى فن شعري قادر على مخاطبة الوجدان الجمعي. استخدم أفرام، الملقب "قيثارة الروح القدس"، أسلوب "المدراش" اليهودي (التفسير الشعري) لصياغة تراتيل غنائية (ܡܕܖ̈ܫܐ) تدمج بين اللاهوت والأساطير المحلية، مثل تصوير المسيح كـ"بطل" يهزم الموت، مستعيرًا رمزية الملاحم البابلية. هذه الانزياحات، كما يوضح سيباستيان بروك، لم تكن بريئة، بل هدفت إلى ترسيخ الهوية السريانية في مواجهة الهرطقات واليهودية المتنافسة.
لكن اللاهوت السرياني لم يكن أحادي النغمة: ففي الكنيسة المشرقية، اختلفت التراتيل النسطورية، مثل تلك المنظومة بواسطة مار نرساي (القرن الخامس)، في تركيزها على "ثالوث التجسد" مقابل تأكيد الأرثوذكس على "الطبيعة الواحدة"، مما يظهر أن الأدب الليتورجي كان ساحة خفية للصراع العقائدي.
الثاني: الأدب التاريخي – بين التوثيق وإعادة تشكيل الماضي
برع السريان في كتابة التاريخ، لكن مؤرخيهم، مثل ميخائيل الكبير (القرن الثاني عشر) ويوحنا الأفسسي (القرن السادس)، لم يكونوا مجرد ناقلين للأحداث، بل حكواتية ينسجون روايات تخدم أغراضًا طائفية. "تاريخ ميخائيل الكبير"، على سبيل المثال، يضخم دور السريان الأرثوذكس في أحداث كبرى مثل الحروب الصليبية، بينما يتجاهل إسهامات النساطرة، في محاولة لتعزيز شرعية كنيسته.
أما "تاريخ الرها" المنسوب إلى يوشع العمودي (القرن السادس)، فيقدم رؤية أكثر تراجيدية، حيث يصوّر السريان كضحايا للغزوات الفارسية والزلازل، في إطار من "لاهوت المعاناة" الذي حول الكوارث إلى اختبارات إلهية. هذه النزعة، كما تحلل سوزان أشبروك هارفي، تعكس محاولة لتعزيز التماسك الداخلي عبر تصوير الذات كشعب مختار يكابد من أجل الإيمان.
الثالث: الأدب العلماني – هامش مهمش أم صوت مضمر؟
رغم هيمنة النصوص الدينية، فإن الأدب السرياني احتفظ بمساحات علمانية نادرة تقدم رؤى إنسانية فريدة. قصيدة "ابن العبري" (القرن الثالث عشر) عن "الحب الأرضي" تعتبر تحديًا صارخًا للأدب الكنسي، حيث تصف العلاقة بين الرجل والمرأة بلغة حسية، مستعيرة أسلوب الشعر العربي المعاصر. لكن هذه النصوص، كما يرى جورج كيرا، بقيت على هامش الذاكرة الجماعية، لأن الأديرة، كحارسة للتراث، فضلت حفظ النصوص الدينية على حساب الأخرى.
الرابع: التفاعل مع الآداب الأخرى – الترجمة كفعل ثقافي
لم يكن الأدب السرياني منعزلاً، بل تفاعل مع الفارسية واليونانية والعربية. فترجمة "كليلة ودمنة" من الفارسية إلى السريانية في القرن السادس (قبل ترجمتها العربية) تكشف عن دور السريان كجسر بين الحضارات. لكن هذه الترجمة، كما يشير فرانسوا دي بلوا، لم تكن حرفية، بل أعادت صياغة الحكايات لتناسب الأخلاقيات المسيحية، مثل تحويل البعث الهندي إلى مفاهيم القيامة.
الخاتمة: الأدب كمرآة للهوية المتعددة الأوجه
الأدب السرياني ليس تراثًا جامدًا، بل حوار مستمر مع الذات والآخر. فمن التراتيل إلى التواريخ المتحيزة، ومن القصص العلمانية إلى الترجمة الإبداعية، تكشف النصوص عن شعب حاول، عبر الكلمة، مقاومة التهميش وصياغة وجوده في فضاء إمبراطوري متقلب. إلا أن هذا الأدب يظل، في الوقت نفسه، سجين سياقاته الطائفية، حيث حولته الانقسامات إلى أرشيفات متنافسة، بدلًا من أن يكون جسرًا للذاكرة المشتركة.
- الفصل الخامس:
التحديات المعاصرة – الهجرة، الهوية، وإشكالية البقاء بين الذاكرة والنسيان.
تواجه الهوية السريانية في القرن الحادي والعشرين اختبارًا وجوديًا غير مسبوق، حيث تهددها تحولات جيوسياسية جذرية، من حروب العراق وسوريا إلى صعود التنظيمات المتطرفة مثل داعش، التي دمرت قرى سريانية عريقة كبخديدا (قره قوش) وسنجار، مجبرة آلاف السريان على النزوح إلى المهجر. وفقًا لتقارير الأمم المتحدة، فقد انخفض عدد الناطقين بالسريانية في موطنهم التاريخي بنسبة 80% منذ عام 2003، مما ينذر بتحولهم إلى "شعب متاحف" في غضون جيلين. لكن هذه الأزمة نفسها أطلقت ديناميكيات جديدة لإعادة اختراع الهوية، عبر توظيف أدوات عابرة للحدود مثل المنصات الرقمية (مشروع "السريانية على الإنترنت") والمؤسسات الأكاديمية (معهد بيت ماردوثو في نيو جيرسي)، التي تحول التشتت إلى فرصة لبناء "وطن افتراضي".
في هذا السياق، تثار أسئلة نقدية حول إمكانية فصل الهوية السريانية عن الإطار الديني التقليدي، خاصة مع تزايد نسبة العلمانيين بين الشباب في المهجر، الذين يعيدون تعريف انتمائهم عبر التركيز على اللغة والتاريخ بدلًا من الطقوس. هنا تقدم تجربة "الاتحاد السرياني العالمي" نموذجًا لحركة ثقافية علمانية تناضل من أجل الاعتراف بالسريان كأقلية قومية في الدساتير العربية، مستندة إلى إرثهم الآرامي ما قبل المسيحية. لكن هذا التوجه، قد يخاطر بفصل السريان عن جذورهم الكنسية، التي حافظت على لغتهم عبر القرون.
على الصعيد اللغوي، تظهر سياسات إحياء السريانية تناقضات عميقة: ففي كردستان العراق، حيث أدرجت السريانية كلغة رسمية عام 2005، تدار عشرات المدارس باللغة الأم، لكنها تفتقر إلى مناهج حديثة تتجاوز تعليم الأبجدية والتراتيل، في المقابل، تنتج المجتمعات المهاجرة في السويد وأستراليا أدبًا سريانيًا معاصرًا، مثل روايات إيفون كيلو، التي تدمج بين السريانية واللغة المحلية، في محاولة لخلق هوية هجينة. هذه الانزياحات تعيد إنتاج السريانية كلغة "نخبوية" تستخدم في الفن والأدب، بينما تتراجع كلغة حوار يومي، مما يطرح تساؤلات حول جدوى مشاريع الإحياء في ظل غياب البيئة الحاضنة.
التحدي الأعمق يتمثل في انقسام السريان أنفسهم حول تعريف هويتهم: فبينما يصر قسم على تسمية "آراميين" لتأكيد امتدادهم ما قبل المسيحية، يتمسك آخرون بـ"سريان" كمرادف للمسيحية الشرقية. هذا الجدل، الذي يحيل إلى صراعات الهوية في القرون الوسطى، يعكس أزمة شرعية تاريخية في مواجهة سرديات القوميات الحديثة (الكردية، العربية، التركية) التي تسعى لاستيعابهم أو تهميشهم.
-في الختام، فإن مستقبل السريانية مرهون بقدرتهم على تحويل المأساة إلى سردية خلاقة، حيث يصبح التشتت مصدرًا لقوة عبر شبكات الاغتراب، واللغة أداة للمقاومة الرمزية في فضاء رقمي لا يعترف بالحدود. لكن هذا المشروع يبقى هشًا أمام إغراءات الاندماج الكامل في الثقافات المهيمنة، التي تقدم لأبناء السريان هويات بديلة أقل تعقيدًا وأكثر نفعية.
الخاتمة:
السريانية ككائن حي – حوار الأزمنة وتحديات الاستمرارية
السريانية، بوصفها لغة وثقافة وهوية، ليست أثرًا متحفيًا يحاكي الماضي، بل كائن حي يتنفس عبر طبقات الزمن، يحمل في حمضه النووي ذاكرة صراعات وجودية وتكيفات خلاقة. فهي، كشجرة زيتون عتيقة، تمتد جذورها في تربة الآرامية القديمة، بينما تزهر فروعها بلونين: أحدهما يطل على ماضيها المسيحي المقدس، والآخر يلامس حاضرها المعولم المعقد. هذا التمازج بين الثبات والتحول هو سر بقائها، رغم كل محاولات القطع مع الجذور أو الاحتواء في هويات أكبر.
التاريخ يعلمنا أن السريانية نجحت في البقاء ليس لأنها حوصرت في برج عاجي، بل لأنها تحولت إلى جسر بين الثقافات: فمن الأديرة المغلقة في القرن السادس إلى منصات التعلم الإلكتروني في القرن الحادي والعشرين، ظلت اللغة تعيد اختراع ذاتها، مستعيرة أدوات كل عصر لضخ الحياة في شرايينها. لكن هذه المرونة تحمل في طياتها مفارقة وجودية: فكلما توسعت السريانية في الفضاء الرقمي أو السياسي، ازداد خطر تحولها إلى "علامة تجارية" ثقافية تفصل عن سياقها الروحي والتاريخي.
اليوم، تقدم السريانية نموذجًا فريدًا لـ"لغات الهوامش" التي ترفض الموت، ليس عبر القوة العسكرية أو الاقتصادية، بل عبر الإصرار على أن تكون ذاكرة حية تذكر العالم بتنوعه المهدد. جهود الإحياء، من تدريسها في مدارس دهوك إلى توثيق لهجاتها المندثرة في قرى طورعبدين، ليست مجرد حنين إلى الماضي، بل إعادة تأكيد على أن الهوية ليست سردية مغلقة، بل حوارًا مستمرًا مع الأجيال.
لكن السؤال المصيري يظل: هل يمكن لهذا الحوار أن يستمر دون أرض تنبت اللغة؟ وهل تكفي الذاكرة الرمزية لتعويض غياب المجتمع الناطق؟ الإجابة، ربما، تكمن في مقولة اللغوي ديفيد كريستال: "اللغات لا تموت لأن أحدًا لا يتحدثها، بل تموت عندما يتوقف الناس عن الحلم بها". السريانية، بهذا المعنى، ما زالت حية لأنها تحمل أحلام شعب يصر على أن يُسمع، حتى لو اضطر إلى ترجمة أحلامه بلغات الآخرين.
في الختام، ليست السريانية مجرد لغة أو مذهب، بل هي اختبار لإنسانية العصر: فإما أن نتعلم من مرونتها كيف نحافظ على التعددية الثقافية، أو نتركها تتحول إلى مجرد حكاية نرويها بألم قبل أن ننام.